استعمل مربع البحث في الاسفل لمزيد من المواضيع
سريع للبحث عن مواضيع في المنتدى
-
Senior Member

من بيداغوجيا الأهداف إلى بيداغوجيا الإدماج :
مزايا التلقين والتعلّم وفق المقاربة بالكفايات
من بيداغوجيا الأهداف إلى بيداغوجيا الإدماج
جدول يقارن بين بيداغوجيا الأهداف وبيداغوجيا الإدماج
المواضيع
بيداغوجيا الأهداف
بيداغوجيا الإدماج
يركّز التعلم وفق المقاربة بالكفايات على العلاقة التفاعليّة بين المتعلّم و المعرفة في سياق تواصلي دالّ من أجل اكتساب آليّات التعلّم الذاتي.
سلوك المعلّم الذي يعمل وفق المقاربة بالأهداف
سلوك المعلّم الذي يعمل وفق المقاربة بالكفايات
[FONT=Wingdings][FONT=Wingdings]
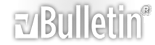
©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى©
المواضيع المتشابهه
-
بواسطة salima في المنتدى قسم التعليم المتوسط العام
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 02-03-2014, 10:38 PM
-
بواسطة linnou في المنتدى قسم التعليم الابتدائي العام
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 02-03-2014, 01:30 AM
-
بواسطة romaissa في المنتدى قسم التعليم الابتدائي العام
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 02-03-2014, 01:06 AM
-
بواسطة walid في المنتدى قسم التعليم الابتدائي العام
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 02-02-2014, 09:29 PM
-
بواسطة admin في المنتدى قسم التحضيري
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 01-31-2014, 08:50 PM
 الاعضاء الذين قرؤوا الموضوع: 0
الاعضاء الذين قرؤوا الموضوع: 0
لا يوجد أعضاء لوضعهم في القائمة في هذا الوقت.
 ضوابط المشاركة
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى
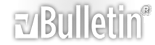



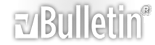

 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس